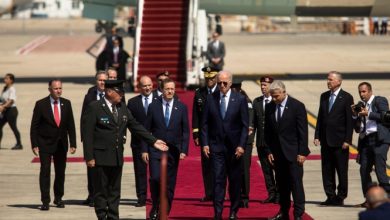من الصحافة الاميركية
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن السلطات الصينية بدأت بناء 119 صومعة إطلاق صواريخ باليستية العابرة للقارات شمال غرب البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مركز جيمس مارتين لدراسة قضايا عدم انتشار الأسلحة بمعهد ميدلبيري أن السلطات الصينية تعمل على بناء 119 صومعة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في منطقة صحراوية قرب مدينة يويمين بمقاطعة غانسو، الأمر الذي قد يشير إلى تعزيز كبير للقدرات النووية لبكين.
وتظهر صور لأقمار صناعية تجارية تلقاها المركز أن العمل يجري في شبكة تطال مئات الأميال المربعة تتضمن 119 موقع بناء متطابقة تقريبا تحتوي على نفس العناصر التي تتضمنها “منشآت الإطلاق لترسانات الصواريخ الباليستية الصينية المزودة بالرؤوس النووية”، كما ذكر تقرير الصحيفة أن الباحثين حددوا في هذه الصور “مركز قيادة تم بناؤه جزئيا”.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بضرب المجموعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا وقد أظهر التوازن الدقيق لمقاربته لطهران: فهو يجب أن يثبت أنه مستعد لاستخدام القوة للدفاع عن المصالح الأميركية، مع الحفاظ على الخط الدبلوماسي الهش مفتوحاً، في الوقت الذي تحاول فيه الدولتان إحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الإدارة الأميركية أكدوا في العلن على أن المسألتين منفصلتان، وقالوا الاثنين إن الرئيس بايدن تصرف بموجب سلطته الدستورية للدفاع عن القوات الأميركية من خلال شن غارات جوية على المواقع المستخدمة لشن هجمات بطائرات بدون طيار على القوات الأميركية في العراق. وقالوا إن ذلك لا ينبغي أن يتعارض مع الجولة الأخيرة من محادثات فيينا لإعادة البلدين إلى الامتثال للاتفاق النووي.
ورأت الصحيفة أن القضيتين متشابكتان بشدة فبالنسبة للإيرانيين فإن المسيرة نحو القدرة على بناء سلاح نووي كانت جزئياً محاولة لإثبات أن طهران قوة لا يستهان بها في الشرق الأوسط وخارجه، والآن تم تعزيز قوة البلاد من خلال ترسانة جديدة من الطائرات بدون طيار عالية الدقة والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد، والتي يتضمن بعضها تقنيات بدت تتجاوز مهارات طهران عندما تم التفاوض على الاتفاق النووي في عام 2015.
وقالت الصحيفة إن جزءاً من هدف بايدن في محاولة إحياء الاتفاق النووي هو استخدامه كخطوة أولى نحو الضغط على إيران لمعالجة قضايا أخرى، وأوضحت أنه لا يُتوقع أن تكون الضربات التي أمر بها بايدن ونفذتها القاذفات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأميركية في وقت مبكر من يوم الاثنين أكثر من انتكاسة مؤقتة لإيران.
وأشارت نيويورك تايمز إلى وجود خطر التصعيد بين الدولتين ففي وقت لاحق اشتبه في أن المجموعات المدعومة من إيران أطلقت صواريخ على القوات الأميركية في سوريا، بحسب المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل واين ماروتو وقالت وسائل إعلام كردية سورية إن الأهداف كانت للقوات الأميركية بالقرب من حقل نفط.
وقالت الصحيفة إنه حتى إذا نجحت الإدارة في إعادة إحياء الاتفاق النووي فسيظل بايدن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد طريقة لمزيد من كبح جماح الإيرانيين، وهي خطوة قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، في اليوم التالي لانتخابه إنه لن يقبل بذلك.
نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية، هال براندس، قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ركز في رحلته الأخيرة إلى أوروبا على الفكرة الرئيسية لسياسته الخارجية، فقال إن التنافس بين أمريكا والصين جزء من صراع أكبر مع المستبدين حول “ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على المنافسة في القرن الحادي والعشرين”. واحتج بايدن مرارا بأن العالم قد وصل إلى “نقطة انعطاف” ستحدد ما إذا كان هذا القرن يمثل حقبة أخرى من الهيمنة الديمقراطية أو عصرا للصعود الاستبدادي.
ولم تكن هذه رؤية بايدن للعالم دائما، ففي عام 2019، سخر من الاقتراح بأن الصين كانت منافسا جادا، ناهيك عن طليعة التحدي الأيديولوجي التاريخي. لكن زعمه أن الصدام المركزي في عصرنا هو التنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية والسلطوية يبدو صادقا – وسيترتب عليه آثار عميقة على السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية الأمريكية.
بالنسبة لإدارة بايدن، يجسد المفهوم ما يقود علاقات أمريكا مع منافسيها الرئيسيين وما هو على المحك. فهو يربط بين تنافس القوى العظمى وتنشيط الديمقراطية الأمريكية ومكافحة الآفات العابرة للحدود، مثل الفساد وكوفيد-19. وهي تجعل أمريكا تركز على استراتيجية كبيرة حقا لتحصين العالم الديمقراطي ضد أخطر مجموعة من التهديدات التي تواجهها منذ أجيال. والسؤال هو ما إذا كان بإمكان الإدارة الآن تحويل هذه الرؤية إلى واقع.
وبينما رأى الرئيس السابق دونالد ترامب التنافس بين أمريكا والصين أنه في المقام الأول صراع على شروط التجارة، يرى بايدن أن المنافسة جزء من “حوار أساسي” بين أولئك الذين يعتقدون أن “الاستبداد هو أفضل طريق للمضي قدما” وأولئك الذين يعتقدون أن “الديمقراطية سوف تسود ويجب أن تسود”.
يواجه مجتمع الدول الديمقراطية ثلاثة تحديات مترابطة. الأول هو التهديد من القوى الاستبدادية – روسيا والصين خاصة. وتتنافس هذه الدول مع أمريكا على نفوذها في جميع أنحاء العالم وتهدد الدول الديمقراطية من أوروبا الشرقية إلى مضيق تايوان. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يفرضونه هو أيديولوجي بقدر ما هو جيوسياسي. وتسعى روسيا والصين إلى إضعاف النظام الدولي الحالي وتفتيته واستبداله لأن مبادئه التأسيسية الليبرالية تتعارض مع ممارساتهما المحلية غير الليبرالية. الخطر، إذن، هو أن موسكو وبكين ستجعلان العالم آمنا للاستبداد بطرق تجعله غير آمن للديمقراطية.
تستخدم روسيا الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة لإفساد الديمقراطيات وتحريض مواطنيها ضد بعضهم البعض، في الوقت الذي أصبحت فيه المجتمعات الليبرالية أكثر استقطابا وقبلية. وتستخدم الصين قوتها السوقية لمعاقبة الانتقادات في الديمقراطيات المتقدمة من أوروبا إلى أستراليا وتزود الحكام المستبدين في العالم بأدوات وأساليب القمع وتعيد كتابة قواعد المنظمات الدولية لحماية الاستبداد بل ومنحه امتيازا. والأكثر خطورة، أن بكين تحقق تقدما كبيرا في مجال التقنيات، مثل اتصالات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي، بهدف نشر نفوذ الصين الاستبدادي وتقدمها على منافسيها الديمقراطيين. خلاصة القول هي أن العالم الذي تقوده الأنظمة الاستبدادية العدوانية القوية سيكون، كما حذر الرئيس فرانكلين روزفلت، “مكانا رديئا وخطيرا” لأولئك الذين يقدرون الحرية.